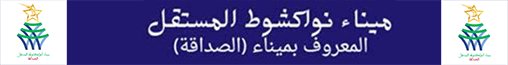مقدمة /// تطرح إشكالية العلاقة بين العقل الناقد والعقل التابع سؤالاً مركزياً في تحليل أدوار النخب داخل المجتمعات النامية. فالمعيار الحقيقي للنضج العقلي – كما يشير فلاسفة التنوير منذ كانط – يكمن في قدرة العقل على التفكير المستقل ومساءلة السلطة والفكرة على السواء، دون الارتهان للأشخاص أو الولاءات الضيقة. في السياق الموريتاني، يبدو أن هذه الإشكالية تتخذ أبعاداً أكثر حدة، حيث تميل قطاعات واسعة من النخبة إلى الدفاع عن الأشخاص لا عن الأفكار، وهو ما يكرس ـ وفق مقاربة أنطونيو غرامشي ـ هيمنة "المجتمع الأهلي التقليدي" على حساب إنتاج "مثقفين عضويين" مرتبطين بقضايا الجماهير.
النخبة بين منطق الحرية ومنطق العبودية
إذا كان "الحر" ـ بالمعنى الرمزي ـ يسعى وراء الفكرة أينما وجدت، حتى وإن صدرت عن خصومه، فإن "التابع" يُعطل ملكة النقد ليبقى أسيراً للأشخاص والرموز. هذه الثنائية ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل هي بنية فكرية ـ اجتماعية تترجم نفسها في خيارات سياسية ملموسة. فغالبية النخب الموريتانية، كما يظهر، اختارت الاصطفاف وراء مصالح ضيقة، ما يفسر استمرار فشلها في لعب دور الوسيط التاريخي بين الدولة والمجتمع.
الدولة العميقة واستدامة الفشل
تسهم ما يسمى بـ"الدولة العميقة" في تكريس هذا الواقع، إذ تعمد ـ بحسب منطق "إعادة إنتاج الهيمنة" عند بيير بورديو ـ إلى اختيار أشخاص محدودي الفاعلية الفكرية والسياسية لقيادة المشهد، حتى تظل دائرة القرار محتكرة من قبل ضباط الجيش، ورجال الأعمال المرتبطين بالسلطة، والقيادات التقليدية التي تأسست شرعيتها على تحالف استعماري قديم. بهذا المعنى، تتكرر عملية إقصاء النخب المستقلة أو القادرة على التفكير النقدي، لأن حضورها يهدد بتعطيل آليات إعادة إنتاج الفساد.
مأزق الانتماء القبلي والسلطة السياسية
لقد ساهم الاستعمار الفرنسي، من خلال تحالفاته مع زعامات قبلية مختارة، في صياغة ما يشبه "الزواج الكاثوليكي" بين البنية القبلية والدولة الحديثة. وبذلك أُسِّس لنموذج سياسي يقوم على التداخل بين الشرعية التقليدية والشرعية البيروقراطية. ومع أن بعض القيادات التقليدية قاومت الانخراط في هذا النسق لرفضها المدرسة الفرنسية أو الإدارة الاستعمارية، إلا أن العقد الأخير شهد عودة رمزية لها عبر واجهات جديدة من "النخب المصطنعة"، وهي في معظمها نخب بلا جذور اجتماعية متينة، لكنها تمكنت عبر النفاق السياسي والشبكات الزبونية من احتلال مواقع القرار، ثم إعادة إنتاج نفس منطق الإقصاء.
الحركات الاحتجاجية ومأزق البديل
في ظل هذا الواقع، تنجذب الجماهير إلى زعامات احتجاجية مثل بيرام ولد الداه ولد اعبيد، لا بالضرورة لعمق مشروعه الفكري أو لقدرته الكاريزمية، بل باعتباره ـ وفق صورة رمزية ـ خشبة إنقاذ يتمسك بها الغريق. هذا التوجه يعكس فقدان الثقة في النخب التقليدية، لكنه في الوقت نفسه يضعف فرص التغيير البنيوي، لأن البدائل المتاحة تبقى محصورة في زعامات تسعى إلى استثمار الخطاب الحقوقي في إطار بحث عن دعم خارجي أكثر مما تستند إلى مشروع وطني متماسك.
المخاطر الاجتماعية لغياب عقل النخبة
إن استمرار تعطيل العقل النقدي داخل النخبة يهدد بخلق حالة من "الاغتراب الاجتماعي"، حيث يُدفع أبناء العامة إلى موقع التجهيل والتهميش. ومع أن هذه الأغلبية الصامتة قد تبدو غير مبالية، إلا أن ردّ فعلها إذا ما تراكمت الإحباطات قد يكون ـ وفق منطق علم الاجتماع السياسي ـ أشد خطورة من بطش النخبة نفسها، لأن انفجارها غالباً ما يأتي خارج أي تنظيم أو وساطة، بما يحمله من تهديد للنسيج الاجتماعي والكيان السياسي للدولة.
خاتمة
تكشف التجربة الموريتانية عن مأزق مزدوج: نخبة تفكر بعقلية التابع، ودولة عميقة تحرص على استدامة هذه الوضعية لضمان إعادة إنتاج نفسها. هذا المأزق يُنتج مشهداً سياسياً مغلقاً، يفتح المجال لزعامات احتجاجية هامشية لكنها تجد صدى لدى جمهور يائس من النخب التقليدية. إن تجاوز هذه الإشكالية لا يمكن أن يتم إلا عبر بروز نخب جديدة من الطبقات المسحوقة، تمتلك القدرة على التفكير النقدي، وعلى بناء مشروع وطني يقطع مع تحالف القبيلة والدولة، ويعيد الاعتبار لدور العقل في توجيه الممارسة السياسية.