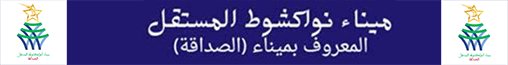ليس الخطر في تعدد الأعراق، بل في من يسعى لتأميم الأحقاد.
تعلو في السنوات الأخيرة أصوات تسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الموريتاني على أسس لونية أو تاريخية، متخذة من “الرق” و”اللون” ذريعة لإعادة رسم خريطة الانتماء الوطني.وتتجسد هذه النزعة في خطاب بعض الناشطين – وفي مقدمتهم بيرام ولد الداه ولد اعبيد – الذين يحاولون فصل لحراطين عن مكون البيظان، في محاولة لإحياء تقسيمات ما قبل الدولة الحديثة.غير أن القراءة العلمية لمفهوم الإثنية تكشف بوضوح أن هذا الطرح لا يقوم على أسس معرفية، ولا يعكس واقع الانتماء الثقافي للمجتمع الموريتاني.
أولاً: أسس الإثنية في ضوء العلم
يؤكد علم الاجتماع والأنثروبولوجيا أن الإثنية لا تقوم على اللون أو المهنة أو التاريخ الطبقي، بل على جملة من العناصر الموضوعية، أهمها:
1. الأصل أو النسب الرمزي المشترك، وهو أساس الإحساس بالانتماء.
2. اللغة المشتركة، بوصفها الوعاء الذي يحفظ الذاكرة الثقافية.
3. العادات والتقاليد والرموز الثقافية، التي تشكل النظام الرمزي للجماعة.
4. الوعي الجماعي بالانتماء، أي إدراك الجماعة لذاتها كوحدة مميزة في إطار مجتمع أوسع.
وعلى ضوء هذه المعايير، يتضح أن الانتماء الإثني يقوم على الثقافة واللغة والوعي المشترك، لا على لون البشرة أو الموقع الاجتماعي.
ثانياً: وحدة النظام الرمزي بين البيظان ولحراطين
تطبيق هذه المعايير على الواقع الموريتاني يقود إلى نتيجة واضحة: أن البيظان ولحراطين ينتمون إلى منظومة ثقافية واحدة.فهم يتحدثون اللغة نفسها (الحسانية)، ويتقاسمون العادات والتقاليد والرموز والقيم، من الضيافة إلى اللباس والشعر والأنساب الثقافية.هذا التوحد في “النظام الرمزي” يجعلهم جماعة إثنية واحدة، مهما تنوعت جذورهم الاجتماعية.
أما كلمة "لحراطين" فأصلها اللغوي أهراضن في اللغة الصنهاجية القديمة، وتعني “الخلاسيين” أو “المزارعين”. وهي تسمية مهنية أكثر منها طبقية، ارتبطت بالحراثة والزراعة، لا بالرق.بل إن بين من يُطلق عليهم هذا الاسم فئات لم تعرف العبودية مطلقًا، ما يدل على أن المصطلح ثقافي لا عرقي.
ثالثاً: في جذور ظاهرة الرق
الرق ظاهرة عالمية قديمة، لا تقتصر على مكون أو عرق معين.وفي السياق الموريتاني، تشير الشواهد التاريخية إلى أن الجماعات الزراعية الزنجية على ضفاف النهر كانت أول من مارس الرق، بسبب حاجتها للأيدي العاملة الزراعية.أما البيظان، فكانوا في الأصل رحلاً لا يعتمدون على العمل الزراعي، ولم يعرفوا الرق إلا بعد أن دخلوا مجال الزراعة وغرس النخيل، فبدؤوا يشترون الأرقاء من الممالك الزنجية المجاورة مقابل الملح والبضائع.وهكذا يتضح أن الرق في هذه البلاد كان نتيجة تحولات اقتصادية واجتماعية، لا ترجمة لتفوق عرقي أو تمييز لوني.
رابعاً: مواجهة دعاية الانقسام
من الخطأ تحويل المظالم الماضية إلى وقود للكراهية. فبدل أن يكون الخطاب منصبًّا على العدالة والمواطنة، يحاول بعض الناشطين المتطرفين تأطير المظلومية كهوية، متجاهلين أن علاج الظلم لا يكون بتفكيك المجتمع.إن خطاب بيرام ولد اعبيد ومن معه لا يخدم لحراطين أنفسهم، بل يعزلهم داخل هوية مصطنعة، ويقطع صلتهم بعمقهم الثقافي العربي الإسلامي.وهو بذلك يكرر خطاب حركة “إفلام” التي تبنّت أطروحات خارجية معادية لموريتانيا وللدولة الوطنية.
خامساً: بين المطالبة بالحقوق واستغلال الذاكرة
من المشروع تمامًا المطالبة بإزالة آثار الرق وتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين، فذلك واجب ديني وأخلاقي.لكن الخطير هو استغلال الذاكرة التاريخية لبث الكراهية وإثارة النعرات.لقد أثبتت التجارب أن الحركات ذات الخطاب العرقي غالبًا ما تتحول إلى أدوات تخدم مشاريع خارجية، وهو ما نبه إليه القائد إفراير جاه في مذكراته حين تحدث عن اكتتاب عناصر من دول الجوار لخدمة أجندات معادية للمجتمع الموريتاني، وللبظان خصوصًا.
سادساً: اللغة والهوية الوطنية
من الغريب أن يُطالب البعض بجعل اللغة الفرنسية لغة التعليم والإدارة بحجة أنها لغة التفاهم، في حين أن الواقع يكذب ذلك.فالفرنسية لا يتقنها إلا قلة من المتعلمين، بينما تظل العربية هي اللغة الوحيدة القادرة على الجمع بين المكونات، لأنها اللغة الأم لمعظم السكان، واللغة المشتركة بين البيظان ولحراطين وسائر المكونات.
سابعاً: العربية وعاء الهوية الجامعة
اللغة العربية كانت ولا تزال اللغة المشتركة بين جميع مكونات الشعب الموريتاني.فما قبل الاستعمار كانت هي لغة القضاء والفقه والمحاظر، التي جمعت فيها العرب والزنوج في حلق العلم والقرآن.ولا يزال الزنوج اليوم ينظمون الشعر بالعربية ويعتمدونها في تدريس علوم الدين، لأنهم يرون فيها لغة العلم والدين والحضارة.وتبرهن ظاهرة الآلمودات المنتشرة في مناطق الزنوج على هذا التشبث العميق بالعربية والإسلام، وهو تشبث نابع من قناعة حضارية بأن العربية هي الوعاء الجامع للدين والثقافة الوطنية.لذلك، فإن أي مساس بمكانتها هو مساس بالوجدان الجمعي الموريتاني كله، لا بمكون واحد.
خاتمة
إن بناء دولة المواطنة يمر عبر فهم علمي للهوية، لا عبر الشعارات الانفعالية.فالإثنية ليست لونًا ولا نسبًا، بل ثقافة ولغة ووعي مشترك.وحين يدرك الموريتانيون هذه الحقيقة، يزول الوهم الذي يروّج له دعاة الفرقة.البيظان ولحراطين وجهان لثقافة واحدة، جمعتهم الصحراء والدين واللغة، ولن يفرقهم خطاب الحقد مهما تلونت شعاراته.
حمادي سيدي محمد آباتي