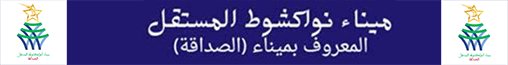من أعظم الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها التنظيمات الصحية هو الخلط بين طبيعة “المهنة” وطبيعة “الملكية”، وبين وظيفة “الاختصاصي” ووظيفة “المستثمر”.
هذا الخلط لم يكن يوماً محلّ قبول في الدول التي نظمت قطاعاتها الصحية على أسس علمية، لأنه يفضي في النهاية إلى شيء واحد: إشغالُ المتخصص عن جوهر وظيفته، أو إدخالُه في دوامةٍ مالية وإدارية ليست من صميم تكوينه، فيتعطل دورُه وتضعف جودة الخدمة، ويُفتح الباب أمام سلسلة من الأخطاء التي يكون ضحيتها الأولى المواطن.
إنّ الصيدلاني حين تُلقى على كاهله أعباء الملكية وإدارة الأعمال، يُنتزع من موقعه الطبيعي الذي بُنيت عليه علوم الصيدلة وأخلاقياتها. فالصيدلاني في الأصل مسؤول عن ضبط جودة الدواء، ومراقبة شروط حفظه، وتحديد بدائله، وتوجيه المريض، ومتابعة التداخلات الدوائية، وتحذير الأطباء والصيادلة المبتدئين من مخاطر الجرعات أو سوء الاستعمال. هذه ليست مهاماً ثانوية، بل هي خط الدفاع الأول عن صحة الناس.
وفي تشريعات أوروبا الغربية — فرنسا نموذجاً — لا يُطلب من الصيدلاني أن يكون رجل أعمال، بل يُطلب منه أن يكون «مسؤولاً فنياً» Pharmacien Responsable، يُعاقب قانونياً إن قصّر في جانب علمي واحد مهما كانت ملكية الصيدلية.
أما المجال التجاري، فمحكوم بقواعد الشركات، ومدعوم بمدير إداري، ومراقَب من هيئات مالية منفصلة. وهذا الفصل ليس ترفاً؛ بل هو شرط لسلامة النظام الصحي.وفي كندا، وتحديداً في مقاطعات مثل أونتاريو، يُفرض على الصيدلاني أن يكون متفرغاً لمهامه المهنية، ولا يُسمح له قانوناً بحمل مسؤوليات مالية أو تعاقدية تجارية تُعيقه عن أداء مهامه.
وفي المملكة المتحدة، يُشترط أن تكون «الرقابة المهنية» منفصلة تماماً عن «الرقابة الاستثمارية»، بحيث يتولى الصيدلاني الجانب الفني بينما يتولى مالك سلسلة الصيدليات أو المستثمر الجانب التجاري، وكلٌّ مسؤول أمام القانون في مجاله.وفي المقابل، فإنّ بعض الدعوات إلى جعل الصيدلاني هو المالك والمدير والمحاسب والمشتري والمفاوض، تستند إلى تصوّر نظري لا علاقة له بالواقع العملي.
فمن جُبل على التخصص العلمي لا يمكن أن يُنتزع منه عشر ساعات يومياً لإدارة حسابات الموردين، ومتابعة المخزون، وملاحقة الشركات لشحن البضائع، والرد على فواتير الكهرباء والضرائب والإيجار، ومواجهة منافسة سوقية شرسة، ثم يُطلب منه بعد ذلك أن يبقى متيقظاً للتفاعلات الدوائية، وأن يُواكب تحديثات البروتوكولات العلاجية التي تتغير كل أسابيع. هذا الجمع غير ممكن في بلدٍ متطور، فكيف يُطلب في بلدٍ نامٍ يفتقر أساساً لعدّة البحث والتحليل وتوسع المهام؟والنتيجة الحتمية لإشغال الصيدلاني بهذه الأعباء معروفة في التجارب الدولية: تتراجع جودة الخدمة، وتضعف الرقابة على التخزين، وتُهمل متابعة الأدوية الحساسة، وتكثر أخطاء صرف الأدوية، ويصبح الصيدلاني — بغير قصد — خطراً على المواطن لا حامياً له.
إنّ الصحة أكبر من أن تُدار بمنطق “مالك ومتجر”، والصيدلاني أعظم من أن يُختزل دوره في “فاتورة وزبون”.
غير أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد. فهناك الخطر المقابل: ماذا لو خرج المستثمر من الصيدليات كلياً؟ هنا يقع القطاع في مأزقٍ اقتصاديّ خطير: الصيدليات — بحكم طبيعتها — مشاريع تحتاج إلى رأس مال مستمر، مخزون باهظ التكلفة، قدرة على التوريد، وتحمل للمخاطر التجارية التي يتردد كثير من الصيادلة عن تحملها. وحين يُترك الصيدلي وحده دون دعم استثماري، تتحول الصيدلية إلى منشأة ضعيفة لا تستطيع الصمود أمام المنافسة أو تقلبات السوق، ثم تغلق أبوابها.
أي إنّ البلد يفقد نقطة بيع للدواء، والمريض يفقد منفذاً صحياً، والصيدلاني يفقد وظيفته ودوره. والنتيجة هي ذاتُها: يُشغَل الصيدلاني عن مهمته، أو تُفلس الصيدلية، وفي كلتا الحالتين يتضرر المواطن.هذه الإشكالية دفعت تشريعات دول كثيرة إلى اعتماد “النموذج المزدوج”: المستثمر يمول، والصيدلاني يراقب. في ألمانيا مثلاً، الصيدلاني هو المدير الفني القانوني، لكن رأس المال يمكن أن يتشارك فيه مستثمرون، مع منع الاحتكار وضبط المنافسة.
أما في تركيا، فالصيدلاني مدير فني، لكنه قد يعين مديراً مالياً متخصصاً ويُمنح مساحة كبرى لتأدية مهامه العلمية. وفي المغرب وتونس، يجري حالياً نقاش مشابه حول ضرورة التمييز بين الرقابة الفنية والملكية حتى لا يتضرر النظام الصحي.
إنّ الحديث عن «جعل الصيدلاني مالكاً» باعتباره “حلاً” ليس إلا خلطاً بين الحاجات المهنية والحاجات الاقتصادية. فالذي يملك الصيدلية يمكنه أن يخسرها، والصيدلاني الذي يُفرض عليه التملك يصبح مديناً لا متخصصاً، وخاضعاً لضغط السوق لا للأخلاق المهنية.
وهكذا يتحول الصيدلاني من “حارس صحة” إلى “مستثمر منهك”، وتتحول الصيدلية من “مرفق دوائي” إلى “مشروع مهدد”. ومن عاش التجربة في الواقع، يعرف أن الصيدلاني حين يجمع بين الدورين ينهار أحدهما: إما تتراجع وظيفته العلمية أو تتردى قدرته التجارية، وفي الحالتين يخسر الوطن صيدلانياً كان يمكن أن يكون قيمة مضافة كبرى.إنّ المخرج الصحيح هو التنظيم الرشيد: إبقاء الصيدلاني في مركزه العلمي، وتمكين المستثمر من القيام بوظيفته المالية، ووضع الدولة لضوابط تمنع الاحتكار وتضمن الجودة، ومساءلة كل طرف في حدود اختصاصه.
بهذه المعادلة وحدها تتوازن المعادلة الصحية والاقتصادية، ويُصان حق المواطن في الدواء الآمن، ويجد الصيدلاني الوقت للقيام بواجبه، وتستمر الصيدليات دون إفلاس، ويُحفظ القطاع من العبث والاختزال.فالصحة ليست تجارة، والدواء ليس سلعة كبقية السلع، والصيدلاني ليس تاجراً وإن امتلك ألف متجر. إنما هو ركنٌ من أركان الأمن الصحي للدولة، ولا يجوز أن يُشغل بما يصرفه عن مهمته، ولا أن يُترك القطاع بلا دعم استثماري.
والبلد — في نهاية المطاف — لا يحتمل مغامرات تنظيرية، ولا يدفع ثمنها سوى المواطن في صحته، والصيدلاني في مهنته، والصيدلية في استمرارها.
بقلم / محمد الأمين محمد المامي - صحفي